
"أطلال"، عنوانٌ اختاره المخرج الجزائري، جمال كركار، لفيلمه، الذي استعرض فيه حياة أبناء القرية الجزائرية المنكوبة، التي لن يحتاج المشاهد إلى كلمات تُخبره بما عاشته هي وأبناؤها، فأنقاض المنازل، وأشجار الخوخ المحترقة، وثمار التفاح اليابسة، كلّها تنطق بما يعجز البشر عن وصفه، هناك في قرية "أولاد علال"، بخطواتٍ حنونةٍ على تلك الأرض المتألمة، التي لم تندمل جراحها بعد، اقترب المُخرج الجزائري الشاب، حاملاً عدسته، فاتحاً أبواب الذكريات، على جُرح غائرٍ لن ولم ينسه الجزائريون. بكل هذا الجنون الذي حدث في تلك القرية يوماً، من حرقٍ وقتلٍ وتدميرٍ، للبشر والحجر، وحتى الحيوانات والنبات، لم ينجُ شيءٌ من ذاك الجنون، ومن تلك الحماقة "اللابشرية"، ومن متوحشين استخدموا الدين درعاً لممارسة أكثر الأساليب وحشية وعنفاً تجاه أبناء وطنهم، في سبيل هدفٍ واحد، ألا وهو الاستحواذ على السلطة لتطبيق أفكارهم الرجعية.
الثورة الإيرانية وتعزيز تواجد إسلاميّي المنطقة
أعطى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ثقة للإسلاميين في المنطقة العربية، بأنّ قيام الحكم الإسلامي، والدولة الإسلامية أمرٌ ممكنٌ يحتاج فقط إلى حشد الناس داخل تنظيماتٍ، ذات واجهةٍ إسلاميةٍ، للسيطرة على الحكم، والاستيلاء على السلطة، وكان إسلاميو الجزائر من ضمن هؤلاء.
بعد تحرير البلاد من استعمار دمّرها لمدّة 132 عاماً، جاءت السبعينيات بانفتاحها، الذي أدّى إلى تدهور أوضاع الاقتصاد، وإلى فوضى في البلاد، دفعت الأقلية الأمازيغية إلى إعلان إضرابٍ عام ضدّ سياسات الرئيس الجزائري، آنذاك، الشاذلي بن جديد، الذي حجّم دور الدولة والمؤسسات الحكومية، وتدهورت في عهده العملة الجزائرية، وتقلّصت رواتب الموظفين، وتدنّى مستوى الخدمات العامة. وقد شارك في تلك الاحتجاجات الطلاب، والنشطاء، والمثقفون، ولم يتردّد أبناء التيار الإسلامي في الجزائر من ركوب موجة الاحتجاجات، معلنين أنّ الفشل الذي تعانيه الحكومة سببه "الابتعاد عن تطبيق شرع الله"، فبدأت تتشكّل التيارات الإسلامية في الجامعات، وأُجبرت النساء على ارتداء الحجاب، ونادت بإغلاق منافذ بيع الخمور.
الإسلاميون استخدموا الدين درعاً لممارسة أكثر الأساليب وحشية وعنفاً تجاه أبناء وطنهم للاستحواذ على السلطة
في عام 1982؛ أعلنت التيارات الإسلامية مطالبتها بتشكيل حكومة إسلامية، تحكم بما أنزل الله، وازدادت أعمال العنف الطلابي في الجامعات في منتصف الثمانينيات، حتى تم اعتقال أكثر من 400 طالب، على رأسهم قيادات الحركة الطلابية للجماعات الإسلامية، وفي مقدمتهم عبد اللطيف سلطاني. وعام 1988؛ تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما دفع آلاف الطلاب في الجامعات للتظاهر، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وقد فشلت الشرطة في التصدي لتظاهرات الشباب، الأمر الذي استدعى على إثره الرئيس بن جديد الجيشَ، للنزول إلى الشوارع.
تولّى الجنرال الجزائري، ووزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، مهمّة السيطرة على التظاهرات، ويقول عمّا رأى وقتها: "كانت المظاهرات أضخم مما نتصور، لم نكن نتخيل حجم هذا الغضب الشعبي، ورغم إعلان حظر التجوّل في كلّ البلاد، نزل الطلاب إلى الشوارع، في تحدٍّ للسلطة، ما دفع الجيش لإطلاق الرصاص، حتى يسيطر على الوضع، ولم يكن هناك مفرّ من ذلك".
التكيف مع الأوضاع، سمة أصيلة في التنظيم الإسلامي
أُجبر الإسلاميون على الاستسلام أمام بنادق الجيش، ومنحهم الهدوء الحذر وقتاً لإعادة تنظيم أنفسهم فقط، وقد أغمضت الدولة، التي لم تسمح حينها بوجود أي معارضٍ، عينها عن الإسلاميين؛ حيث سمحت لهم باستخدام المساجد لإعادة تنظيم أنفسهم، وممارسة أنشطتهم السياسية، والتوسع المجتمعي عن طريق الأعمال الخيرية، وزيادة تواجدهم القوي في الأحياء الفقيرة، فاستطاعوا، رغم الانقسامات الداخلية التي عانوها، تأسيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، بقيادة زعيمهم "عباسي مدني"، وبدأت الجماعات الإسلامية، منذ أوائل الثمانينيات، إقامة معسكرات التدريب على الجهاد المُسلح، تحت سمع وبصر السلطات، التي لم تلقِ بالاً لهذا الأمر، وجاءت حرب الخليج الأولى، لترجّح كفّة الإسلاميين، وتغيّر المعادلة السياسية، فازداد عدد مؤيديهم، خاصة بعد اعتقال عباسي مدني، وعلي بلحاج، الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ.
أُجريت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في 26 كانون الأول (ديسمبر) عام 1996، وحشدت الجبهة، رغم مقاطعة الناخبين للانتخابات، 60% من أصوات الناخبين، وقد جاء في مذكرات عضو مجلس الدولة آنذاك، علي هارون: "جولةٌ ثانيةٌ من الانتخابات، كانت تعني إمّا حرباً أهليةً، أو دولةً إسلاميةً، وبذلك كان يجب إيجاد حلٍّ، بطريقةٍ أو بأخرى، فلن تكون هناك انتخاباتٌ بعد هذه، لأنّ الديمقراطية ليست من الدين، هل يمكننا أن نترك هؤلاء الناس يستحوذون على السلطة، ويهدمون الوطن، ما العمل؟".
احتشد آلاف من المتظاهرين، استجابةً لدعوات اليسار، وتنديداً بالأصولية، وصل تعدادهم إلى نصف مليون، وكان على الجيش أن يتدخّل لوقف تقدم الجبهة الإسلامية، واستحواذها على السلطة، التي سوف تأخذ الجزائر إلى أحضان الأصولية الإسلامية، بلا عودة.
السلطة السياسية المأزومة
بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وُضعت السلطة السياسية في مأزق حقيقي، خاصةً بعد تأييد البعض لفكرة إلغاء الانتخابات، وتدخّل الجيش فعلاً لإلغاء الانتخابات، وأجبر الجنرال "خالد نزار"، الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة، على الهواء مباشرة في التلفاز، وتم حلّ البرلمان، وعاد الجيش لتولي السلطة، وبدأت مهمّة البحث عن رئيسٍ جديدٍ، وكان الاختيار يدور بين رجلين: الأول هو "محمد بوضياف"، أحد زعماء حزب الاستقلال المعروفين، وكان حينها منفياً إلى المغرب منذ ثلاثين عاماً. والثاني: كان حسين آيت أحمد، زعيم الجبهة الاشتراكية، الذي رأى أنّ ما فعله الجيش انقلابٌ على الديمقراطية، ورفض تعيينه رئيساً من قِبل الجيش.
شكّلت العشرية السوداء أعواماً مظلمةً في تاريخ الجزائر طوَت الكثير من الأسرار لكنّها لم تستطع أن تطوي الجراح
تم اختيار بوضياف، وأعيد إلى الجزائر باستقبال حافل من الجنرالات، وعُيّن رئيساً للبلاد، كان الرجل المناسب للمكان المناسب، فقد كان مناضلاً معروفاً بنزاهته، لكنّه عاد لبلاده الواقعة تحت سطوة رجال الجيش المشتبه بفسادهم، علاوة على إمساكه بزمام بلاد تعيش حالة من التخبط الدستوريّ، فمؤسساته لم تتكوّن بعد، ولم يكن من مؤسسة فعلية في الجزائر سوى مؤسسة الجيش، التي أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، وبناءً عليه تم اعتقال كل رموز الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أعلنت عن اسمها الجديد لاحقاً، الجبهة الإسلامية المُسلحة للإنقاذ، "جيا"، وجاء الردّ على سياسات بوضياف، الذي رفض مصالحة الإسلاميين، وكان آملاً في معالجة الفساد، باغتياله بعد خمسة أشهر فقط من توليه السلطة، علناً أمام الشعب الجزائري على الهواء مباشرة، في إشارة واضحة، إلى أنّ لا أحد ينجو من القتل.
الحرب المعلنة بين الشرطة والإسلاميين
خرج الشعب الجزائري بتظاهرات بالآلاف، فاغتيال بوضياف كان صفعةً قويةً لهم، ورفع المتظاهرون لافتاتٍ كتب عليها "قتلتموه بكراهية"، إشارةً إلى توجيه أصابع الاتّهام إلى قياداتٍ في الجيش الجزائري، الذي أعلن أنّ الفاعل أحد عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة، لكنّه، في الوقت نفسه، لم يكشف عن هوية القاتل، ولم يشرّح الجثة لمعرفة ملابسات الحادث.
كان مقتل بوضياف بداية المعركة الحقيقية التي اشتعلت لاحقاً بين الإسلاميين والشرطة؛ فقد بدأت سلسلة اغتيالاتٍ يومية لعناصر الشرطة، ونشبت صراعاتٌ دمويةٌ، طالت كلّ من كان يعارض الجبهة الإسلامية. كان أبرزها اغتيال مقدِّم البرامج التلفزيوني الشهير "إسماعيل يفصح"، وقد تجمهر الآلاف في جنازته التي بثّها التلفزيون، تكريماً للراحل.
جاء الردّ على الرئيس بوضياف الذي رفض مصالحة الإسلاميين وسعى لمعالجة الفساد، باغتياله بعد خمسة أشهر
كان على الجيش وضع حدٍّ للفوضى التي عمّت الشوارع، وللاغتيالات التي أنهكت الشرطة والجيش، ما شكّل مبرراً قوياً لحملات الاعتقالات العشوائية، وحملات الاختفاء القسري، وأصبح الشعب كلّه مشتبهاً به، وأقيمت محاكم خاصةّ، وأنشِئت وحدات "النينجا" لتطويق الشوارع والأحياء السكنية.
وسط كلّ تلك الإجراءات المشدَّدة، ارتكبت الجماعة الإسلامية المسلحة، مجزرةً راح ضحيتها 250 قتيلاً، في حوالي 9 ولايات، وقد ارتكبت معظم تلك المذابح قرب معسكرات للجيش، وهو دعا للتساؤل: أين كان الجيش من كلّ هذا؟
"علي بن هاجر"، زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة، الذي اعترف مؤخراً بانقلاب الجماعة على أنصارها، وذلك الغضب الذي جعلها ترتكب مجازر بحقّ المدنيين، حتى ممّن كانوا يناصرونهم، لكنّه أشار بأصابع الاتهام للجيش الذي أكّد بارتكابه مذابح للمدنيين.
مرّت سنوات عديدة من التعتيم الإعلاميّ على الأحداث داخل الجزائر، واستمرّت الدولة بإخفاء رأسها في الرمال، إلى أن علت الأصوات في المجتمع الدُوليّ، تتهم الجيش بارتكاب مجازر بحق المدنيين، فبثّ التلفزيون الرسمي صوراً لجثث المسلحين، الذين يُقتلون من قِبل قوات الجيش.
"الوئام المدني" قصاصاً لدماء الشهداء
في عام 1998؛ عرض الجيش على الجبهة المسلحة للإنقاذ، صفقة المصالحة، مقابل أن يُسلمّوا أسلحتهم للجيش، وألّا يعودا لأعمال العنف مرة أخرى، وكانت البلاد حينها تعاني فراغاً سياسياً، انتهى بتعيين المرشح الجديد، الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، الذي أجرى استفتاء شعبياً لوضع حدٍّ للعنف، واستمرت المفاوضات بين الجيش وعناصر الجماعات المسلحة، انتهت بتسليم العناصر أسلحتهم للجيش، وعودتهم للحياة المدنية، وكأنّ شيئاً لم يكُن! وضجّت الصحف بأخبارهم تحت عنوان "التائبون"، الأمر الذي استفزّ أميرهم "علي بن هاجر"، فقال: "لسنا بتائبين، لأنّنا لم نرتكب خطأً من البداية، ولم نُسلّم أنفسنا للسلطة. السلطة هي التي صعدت إلينا في الجبال، وطلبت الحوار معنا، وقد وافقنا عليه"، لم يكن "الوئام المدنيّ" كافياً، فقد اندلعت أعمال الشغب مرة أخرى، ما دفع الجيش لقمع التظاهرات، التي طالبت بالثأر للقتلى على يد الإسلاميين، واتهمت الجيش بالتواطؤ معهم لتصفية ذويهم.
هكذا شكّلت العشرية السوداء أعواماً مظلمةً في تاريخ الجزائر، طوَت الكثير من الأسرار، لكنّها لم تستطع أن تطوي الجراح الغائرة في قلوب الجزائريين، الذين شاهدوا المجازر، ووواجهوا القتل، وعاشوا الخوف، وعانوا الفقر والتهميش، فأصابع الاتهام ستبقى موجّهة، ودماء الشهداء لن تجف ولن تنضب، لأنّ الأجساد تنادي بالقصاص.


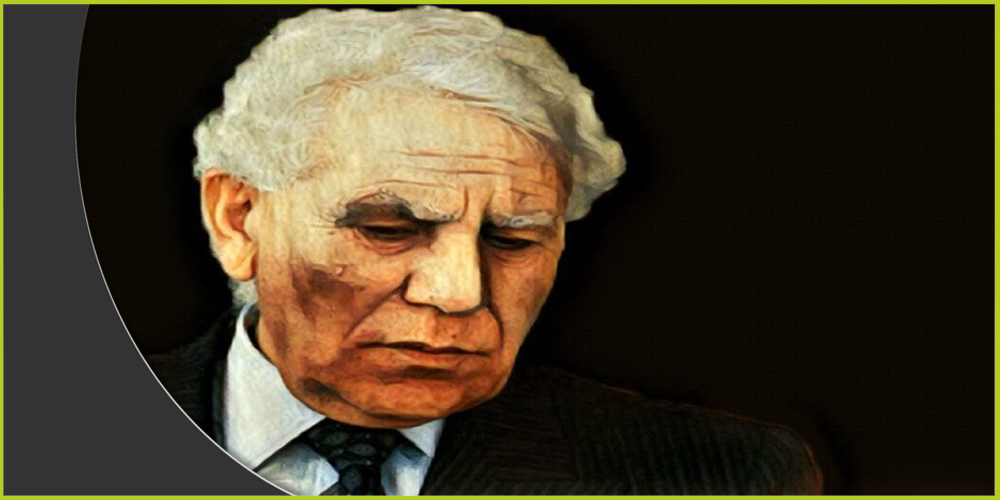

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86...%20%D9%81%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_0.jpg.webp?itok=4cnIFmtL)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6629829b4c59b716685d4621.jpg.webp?itok=6vK3V0aB)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_0_0_0_0.png.webp?itok=WL9ET923)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/lzndny_56_0_0.jpg.webp?itok=F_H9nhGv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A_0.png.webp?itok=vMIlVqe0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%82%D9%8A%D8%B3_26_0.jpg.webp?itok=i5ujY09b)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_71_0_0_0_0.jpg.webp?itok=jgwzfyG-)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_55_0_3_0_1_0_0.jpg.webp?itok=rTmxP5p0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_0_0_2_0.jpg.webp?itok=Os7pCjBI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/987341-357453262.jpg.webp?itok=f9Ila1kA)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1-1410918.jpg.webp?itok=EdowmzVE)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/19_2024-638485269846866467-686.jpg.webp?itok=tQ-ctzaG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Xw6c0w_b)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1-1676794.jpg.webp?itok=Ag0VQppY)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD_0.jpeg.webp?itok=qj7uX1BI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1280x960_11.jpg.webp?itok=RRBT-PHj)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)

