
حين كان الأزهريون يحاصرون الشيخ علي عبد الرازق، ويحاكمونه على كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، عام 1925، إلى درجة أنّ الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي الديار المصرية حينها، اتهم الكتاب بأنّه يهدد، ضمنياً، نظام العقيدة الإسلامية بكامله، وذلك بمحاولته هدم أحد أسس هذا النظام؛ "عقيدة الخلافة"، انبرى المجاهد الجزائري، عبد الحميد بن باديس، للدفاع، من وجوهٍ عدة، عن طرح عبد الرازق، وإن بشكل غير مباشر؛ عبر نقد الخلافة كما طُبقت في التاريخ، ومعارضة تحويلها إلى مشروع سياسي، يجري حشد المسلمين تحت ظلاله.
سيرة فكرية
من أجل فهم كيف وقف هذا الشيخ في وجه العاصفة التي جعلت من الدفاع عن عبد الرازق من موقع "إسلامي" شبه مستحيل، (وإن كان هناك دفاع من قِبل التيار العلماني في مصر، وقد أضعف في الواقع موقف عبد الرازق كعالم ديني)؛ يجب تتبع السيرة الفكرية لابن باديس، وهي السيرة التي تتموضع داخل المدرسة الإصلاحية، كما جسدها الإمام محمد عبده، وعبّرت عنها مجلة "المنار"؛ وهي المدرسة التي يضرب عبد الرازق بسهمٍ فيها؛ وتكمن المفارقة في هجوم أحد مؤسسي الإصلاحية الكبار، الشيخ رشيد رضا، على كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، واتهامه بأنّه "آخر محاولة يقوم بها أعداء الإسلام لإضعاف هذا الدين وتجزئته من الداخل".

على كلٍّ، ولد ابن باديس، كما يقول كاتب سيرته الفكرية، محمد الميلي، في كانون الأول (ديسمبر) 1889، في أسرة عريقة، في قسنطينة بالجزائر، يمتد نسبها إلى عائلة مالكة؛ هي عائلة المعز الصهناجي الأمازيغية، وأتمّ حفظ القرآن الكريم في الثالثة عشرة من عمره، وتعلّم مبادئ العربية في صغره، ثم انتقل إلى جامع الزيتونة؛ حيث درس في الفترة ما بين 1908 و1912.
اقرأ أيضاً: رشيد رضا والإصلاح الديني ... انقلاب على الانقلاب
خلال دراسته اتصل بروافد الفكر الإصلاحي الآتي من المشرق، وهو الفكر الذي ظلّ بمثابة البطانة الثقافية؛ لإسهامه السياسي في تاريخ الجزائر، وكانت جمعية "العلماء المسلمين"، التي أسسها، قائمة على فكر "المنار"؛ لذلك اضطلعت الجمعية بالهجوم على الطرق الصوفية، وإحياء "الكتاتيب" في كافة أرجاء الجزائر، ولم يكن تأسيسه لصحيفة "المنتقد" سوى صدى لأيديولوجيته الإصلاحية في مواجهة شعار الصوفية "اعتقد ولا تنتقد".
معالم إصلاحية
مثل كلّ مفكري الإصلاح (وابن باديس هو آخر نسخة من مدرسة الإصلاح) لم يهتم ابن باديس بالاستعمار كظاهرة سياسية بحتة وطارئة؛ بل ربط بينه وبين تخلّف المجتمعات الإسلامية في شتى النواحي: الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية، ورأى بين ظاهرتَي التخلف والاستعمار وشيجة قربى ينبغي فصم عراها.
اقرأ أيضاً: كيف نظر الإصلاحيون إلى "الإسلام الصحيح"؟
في سبيل ذلك؛ لم يكن هناك مفرّ من التثاقف مع الغرب، والأخذ بأسباب النهوض، وكذلك العودة إلى التاريخ، لا لاستلهام مرحلة ذهبيةٍ يمكن أن تُعاش مجدداً، كما فعل الإصلاحيون من قبله، بل من خلال القراءة النقدية لتجارب الأمة التاريخية شاملة ودون انتقائية (على عكس مفكري الإسلام الحركي)؛ وكانت هذه النظرة الشمولية بمثابة الرافعة المنهجية في هجومه على الخلافة، ونقده الحاد للتجربة التاريخية للمسلمين، أو ما يسميه "الإسلام الوراثي"؛ أي الموروث تاريخياً دون تمحيص أو نظر.
بالغ ابن باديس في الهجوم على دعاة الخلافة بقرنهم بالأيدي الأجنبية التي تحرك شعار الخلافة في الخفاء
وفي هذا تفوق ابن باديس على محمد عبده والأفغاني معاً، اللذين رأيا في الماضي مثلاً أعلى، من وجهٍ ما؛ إذ إنّ هذا الماضي، في نظره، ليس محلاً للتقديس والاستلهام، بقدر ما هو خبرة تاريخية يمكن الاستعانة بجوانبها الإيجابية في خوض المعركة ضدّ التخلف الذي يمثله "الإسلام الوراثي".
رأى ابن باديس؛ أنّ "الإسلام الوراثي" لا يمكن أن ينهض بالأمة؛ لأنّ الأمم لا تنهض إلا بعد تنبّه أفكارها، وتفتّح أنظارها؛ والإسلام الوراثي مبني على الجمود فيه، لا النظر، ومع ذلك امتلك إدراكاً حاداً للجوانب الإيجابية، على ضمورها في الإسلام التاريخي؛ إذ إنّه حفظ للأمة شخصيتها (وهو مشغول بالحفاظ على الشخصية الجزائرية في مواجهة المسخ الفرنسي الشامل للمجتمع الجزائري)، ولغتها، وشيئاً كثيراً من الأخلاق، ويتفق معه في هذا المفكر العربي، فهمي جدعان، في إنصافه للإسلام التاريخي في كتاب "أسس التقدّم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث"، عام 1988.
ضدّ الأوهام المقدسة
أتى عبد الرازق، على حدّ قول ألبرت حوراني في "الفكر العربي في عصر النهضة"، عام 1961، "بنظرية تاريخية جديدة حول أمور كانت النظرة التاريخية المقبولة بشأنها بمثابة عقيدة دينية"، ومع ذلك لم يكن هذا ليبرر العاصفة ضدّه على كلّ حال، ولعلّ في العنف اللفظي لدى رشيد رضا؛ الذي أتم انقلابه على الإصلاحية العربية قبل صدور الكتاب بعقد على الأقل، وفي دفاع ابن باديس (سليل الإصلاحية) عنه، ما يؤكّد أنّ المسألة لا تتعلق بأصول الدين الإسلامي، بقدر ما تتعلق بتغييرات سياسية وفكرية حطمت محاولات عبد الرازق في استئناف القول الإصلاحي، بعد أن هدم رشيد رضا معبد الإصلاحية على من فيه.
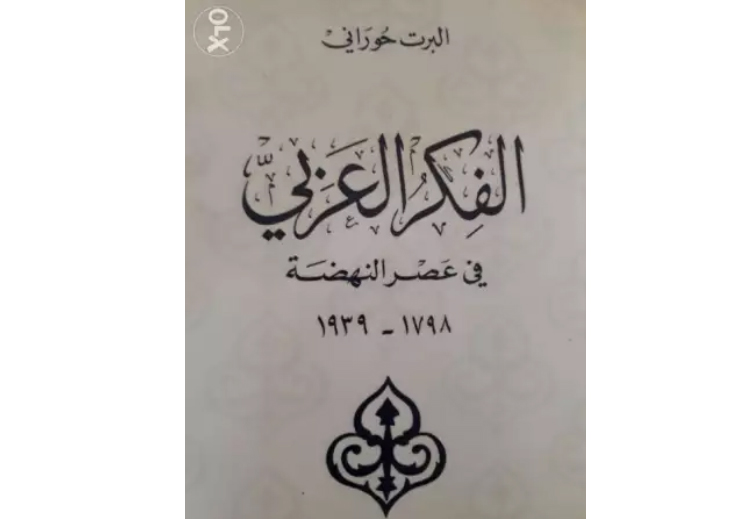
على عكس عبد الرازق؛ كان ابن باديس يتخذ موقفاً إيجابياً من الخلافة (على المستوى النظري)؛ إذ عدّها بمثابة "المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحلّ والعقد من ذوي العلم والخبرة والنظر، وبالقوة بالجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع"، إلّا أنّ هذا المنصب لم يظل على ذلك، في رأيه؛ إذ أوفى بمهمته السياسية في صدر الإسلام، ثم انهارت رمزيته ومركزيته السياسية، وتعددت مراكز الحكم في الشرق والغرب، وقد أتى هذا التعدد بالهدم على معنى وصورة الخلافة.
اقرأ أيضاً: النفّري الذي اتسعت رؤيته فضاقت عبارته: الجهل عمودُ الطمأنينة
إذاً، اختلف ابن باديس مع عبد الرازق في تقييمه السلبي الشامل للخلافة؛ إذ لم ينكر مبدأ الخلافة في ذاته، كما تبين، لكنه اتفق معه في الجوهر السياسي للمسألة؛ وهو استحالة قيامها، ووجوب عدم السعي إلى إحيائها مجدداً.
وبهذا المنطق استنكر ابن باديس دعوات شيوخ الأزهر المطالبة بعودة الخلافة التي دخلت طور الامتناع، والخلافة التي ألغاها أتاتورك لم تكن إلا نظاماً حكومياً خاصاً بتركيا الإمبراطورية، وإن كان قد اكتسب رمزيةً ما عند المسلمين، دونما أساس.
كان الفارق بين عبد الحميد بن باديس وعلي بلحاج كالفارق بين محمد عبده وعبد السلام فرج
شنّ ابن باديس هجوماً شرساً على دعاة الخلافة، على اعتبار أنّهم "يفتنون الناس ويمتهنون إلهاءهم بما ليس في الإمكان تحقيقه"؛ ولأنّ "قيام الخلافة لن يتحقق، والمسلمون سينتهون يوماً ما، إن شاء الله، إلى هذا الرأي".
في كتابه "الماضي في الحاضر: دراسات في تشكلات التجربة الفكرية العربية"، عام 1997، حاول فهمي جدعان تفسير موقف ابن باديس المعادي لدعوات إعادة الخلافة، بالإحالة إلى البيئة السياسية الجزائرية؛ إذ إنّ نقد الخلافة يعني عملياً فصل الدين عن السياسة؛ وقد كان ذلك بمثابة الضمانة الوحيدة لمنع الإدارة الفرنسية من التذرّع بتدخّل علماء الدين في السياسة وبالتالي السيطرة على المؤسسات الدينية والثقافية.
إلا أنّ هذا لا ينفي القدر الكبير من المجازفة في الوقوف في وجه التيار المُتفجع من سقوط الخلافة، الذي أحيا القول الفقهي والسياسي فيها، في ظلّ الهيمنة الاستعمارية على العالم الإسلامي المُهشّم، ولا ينفي كذلك الصعوبة الناجمة عن محاولة العودة بالمسألة السياسية إلى رحاب الإصلاحية الإسلامية التي انقلب عليها أحد كبار مؤسسيها (رشيد رضا)، حتّى بات السائر في مسارها، المحفوف بالمكارِه، ملكياً أكثر من الملك المنقلب على نفسه.
ومع ذلك، يبقى السؤال: إذا كان ابن باديس يرفض الخلافة كمشروع سياسي، الآن وهنا، فأيّ شكل للنظام يمكن أن يرتضيه؟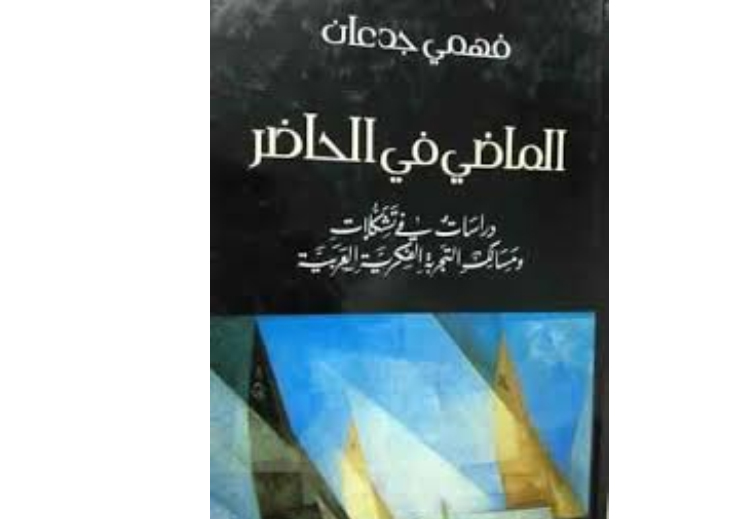
في سبيل الدولة الوطنية
للإجابة عن سؤال بديل الخلافة؛ يؤكّد ابن باديس أنّ الشعب المستقل (لا الأمة برمتها)، هو صاحب القول الفصل في النظام السياسي الذي يريده، ولا يجوز أن يُستغل الدين في هذا؛ فمثل كلّ الإصلاحيين؛ لم يتناول ابن باديس الدولة كإشكالية نظرية (هذا شيء متأخر في الوعي العربي عموماً، بدأ مع المفكّر المغربي، عبد الله العروي)، لكنَّه عنيَ بتبيان علاقتها بالدين والأمة.
لذا فقد حدّد ابن باديس تصوّره للنظام السياسي الحائز للشرعية في الراهن في ثلاثة عشر أصلاً، ترتبط بجملتها بنموذج مغاير لنظام الخلافة التاريخي، ولشكل الدولة الإسلامية كما تجلّى في أدبيات الجماعات الدينية لاحقاً، وهي:
1- "لا حقّ لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة؛ فهي صاحبة الحقّ والسلطة في الولاية والعزل"، بالتالي؛ يكرّس ابن باديس لمرجعية الأمة على أساس أنّها مصدر السلطات.
2- "الذي يتولى أمراً من أمور الأمة هو أكفؤها، لا خيرها في سلوكه"، وبذلك يسحب بساط الشرعية من حكم "رجال الدين" أصحاب التفوق الأخلاقي الأبدي.
3- "لا يكون أحدٌ بمجرد ولايته أمراً من أمور الأمة خيراً من الأمة" في استهداف واضح لأكثر مبررات الاستبداد فاعلية.
4- "للأمة الحقّ في مراجعة أولي الأمر؛ لأنّها مصدر سلطتهم وصاحبة النظر في ولايتهم وعزلهم" في إقرار لمبدأ المراقبة والمحاسبة.
5- "هناك حقّ للوالي على الأمة إذا رأت استقامته؛ فهي شريكة في المسؤولية" وبالتالي ترتبط طاعة السلطة بسلامة سياساتها.
6- "حقّ الوالي على الأمة في نصحه وإرشاده" وهو مبدأ استوحاه ابن باديس من خطبة الخليفة الأول؛ الصحابي الجليل "أبي بكر الصديق".
7- "للأمة حقّ في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم، وحملهم على ما تراه هي لا ما يرونه"؛ وهو مبدأ يجرّد الاستبداد من أيّة مشروعية محتملة.
8- "على من يتولى أمراً من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها؛ ليكونوا على بصيرة، ويكون [الحاكم] سائراً في تلك الخطة عن رضى الأمة"، وهو ما يعرف في الفكر السياسي الحديث بالبرنامج السياسي.
9- "لا تحكم الأمة إلا بالقانون الذي رضيت به لنفسها، وما الولاة إلا منفّذون لإرادتها؛ فهي تطيع القانون لأنّه قانونها، لا لأنّ سلطة أخرى لفرد أو جماعة فرضته عليها" في تحدٍّ سابق لأوانه لكلّ نظريات الحاكمية الإلهية.
10- "الناس (وليس المسلمون وحدهم) أمام القانون سواء" وهو إقرار صريح بمبدأ المواطنة.
11- "من الواجب صون الحقوق؛ فلا يضيع حقّ الضعيف".
12- "من الواجب حفظ التوازن بين طبقات الأمة" كأثر لحساسية جديدة دشّنها المدّ الاشتراكي في العالم العربي.
13- "المسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية".
اقرأ أيضاً: بعد ربع قرن على مناظرة أبو زيد وعمارة.. هل اختلف خطاب الإسلامويين؟
وتؤسّس الأصول الثلاثة عشر (في المجمل) لتصور عصري للسياسة ونظام الحكم، تَنَاسَل من تصور الإصلاحية التي أرسى جذورها محمد عبده؛ وفي قلب هذا التصور يكمن مبدأ مدنية السلطة، وفي منطقه؛ إنّ الأمة هي الأساس، وليس الحاكم (كما في فقه السياسة الشرعية)، أو الشريعة (كما في اللاهوت المصطنع لمنظري الإسلام السياسي).
في مديح أتاتورك
بالغ ابن باديس في الهجوم على دعاة الخلافة؛ بقرنهم بـ "الأيدي الأجنبية التي تحرك شعار الخلافة في الخفاء [في إشارة إلى بريطانيا]"، وهو لا يتعجب من سعي بريطانيا إلى إحياء الخلافة من أجل خلق قيادة للشعوب الإسلامية، تسهُل السيطرة عليها، وإنما العجيب بالنسبة إليه؛ "أن يُدفع في تيارها [تلك الدعوات] المسلمون، وعلى رأسهم أمراء وعلماء".
ويشير إلى مساعي علماء الأزهر، ومن خلفهم الملك فؤاد، في إقامة خلافة في مصر، حيث يقول: "في هذا الاندفاع ما يُتحدث به في مصر، فيتردّد صداه في الصحف في الشرق والغرب، وتهتم به صحافة الإنجليز على الخصوص، يتحدثون في مصر عن الخلافة كأنّهم لا يرون المعاقل الإنجليزية الضاربة في ديارهم".
اقرأ أيضاً: جمال الدين الأفغاني: هل كان "عراب الصحوة" إسلامياً؟
لكنّ المفاجأة التي تنتاب الباحث في سيرته الفكرية؛ كانت موقفه من مصطفى كمال أتاتورك "الشيطان الأكبر" عند الشيوخ الرسميين والحركيين الإسلاميين؛ إذ كتب عقب وفاة أتاتورك، عام 1938، ما صدم به الذين احتفوا بموت أتاتورك على سبيل الشماتة والتشفي: "الآن خُتمت أنفاس أعظم رجل عرفته البشرية في التاريخ الحديث، وعبقري من أعظم عباقرة الشرق الذي يطلعون على العالم في مختلف الأحقاب؛ فيحولون مجرى التاريخ، ويخلقونه خلقاً جديداً؛ ذلك هو مصطفى كمال أتاتورك، باعث تركيا من شبه الموت إلى حيث هي اليوم من الغنى والعزّ والسمو".
اقرأ أيضاً: بين محمد عبده وفرح أنطون.. ما تبقى من سجالات النهضة المُجهضة
أما حيثيات هذا الاحتفاء؛ فيردّها ابن باديس إلى أنّه: "لو لم يخلق الله المعجزة على يد كمال لذهبت تركيا وذهب الشرق الإسلامي معها؛ لكنّ كمالاً جمع تلك الفلول المبعثرة فالتفّ به (حوله) إخوانه من أبناء تركيا البررة، ونفخ من روحه في أرض الأناضول؛ حيث الأرومة التركية الكريمة، وحيث الشعب النبيل الذي قاوم الخليفة الأسير (يقصد تبعيته لقوات الحلفاء المحتلة) وحكومته المتداعية، وشيوخه الدجالين من الداخل، وقهر دول الغرب، وفي مقدمتها إنجلترا من الخارج؛ فأوقف الغرب عند حدّه، وكبح جماحه، وكسر غلواءه، وبعث في الشرق الإسلامي أمله، وضرب له المثل العالمي في المقاومة والتضحية؛ فنهض يكافح ويجاهد".
اقرأ أيضاً: لماذا يُتهم علي عبدالرازق بتمهيد الطريق للإخوان المسلمين؟
أما الأمثلة التي ضربها الشيوخ كدليل على عداء أتاتورك للإسلام فقد جعل منها ابن باديس دليلاً على حُسن إيمانه، وعلى رأسها ترجمة القرآن بالتركية؛ إذ يقول: "لقد تُرجم القرآن إلى التركية، ليأخذ الأتراك الإسلام من معدنه، ويستسقونه من نبعه؛ ويتمكنون من إقامة شعائره [الإسلام]؛ فكانت مظاهر الإسلام في مساجد تركيا تتزايد في الظهور عاماً بعد عام، حتى كان المظهر الإسلامي العظيم يوم دفنه والصلاة عليه".
بل يقيم ابن بايس مفاضلة بين تطبيق الشريعة وتحقيق الاستقلال السياسي لصالح الأخير، يقول: إنّ "مصطفى أتاتورك نزع عن الأتراك الأحكام الشرعية، وليس مسؤولاً في ذلك وحده (يشير إلى مسؤولية العلماء الذين تجمدوا على المدونة الفقيهة الموروثة)، وفي إمكانهم (الأتراك) أن يسترجعوها متى شاؤوا، ولكنّه أعاد لهم حريتهم واستقلالهم وسيادتهم وعظمتهم بين أمم الأرض، وذلك ما لا يسهل استرجاعه لو ضاع".
في المجمل؛ أُجهض مشروع ابن باديس الإصلاحي؛ إذ سارت الدولة الجزائرية الوليدة في درب القومية العلمانية، وسار الإسلاميون من بعده في مسار تحقيق الدولة الإسلامية، نحو التمايز عن العالم والانفصال عنه؛ فكان الفارق بينه وبين علي بلحاج، كالفارق بين محمد عبده وعبد السلام فرج، لكنّ هذا لا يمنع ضرورة العودة إلى مقدمات ونتائج المدرسة الإصلاحية، التي لا يبدو أننا تجاوزنا إشكاليتها كثيراً، رغم تبدّد شرعيتها التاريخية.


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/taaaa_0_0_0_0.jpg.webp?itok=FzzzFHwG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/jly_5.jpg.webp?itok=6OoiDb6D)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_162_0.jpg.webp?itok=XKJf_Sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_63_0_8_0.jpg.webp?itok=BDMbKc_I)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/320245214338451859503_0_0_0.jpg.webp?itok=1w3HGcUv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_0_0_1_0_0.jpg.webp?itok=NaGIRPy6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_4_0_0_1_0.jpg.webp?itok=YqqMyIP6)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/g1_1_0.jpg.webp?itok=G79shThP)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%861_2_0.png.webp?itok=hdGbwfib)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/00_59.jpg.webp?itok=9pXj2Dv1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0.jpg.webp?itok=mKmo_T5S)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%87%D9%86%D8%AF_15.jpg.webp?itok=RB8PuNXP)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/news-240423-sudan.harb__0_0_0.jpg.webp?itok=hyWie-m8)






![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)


