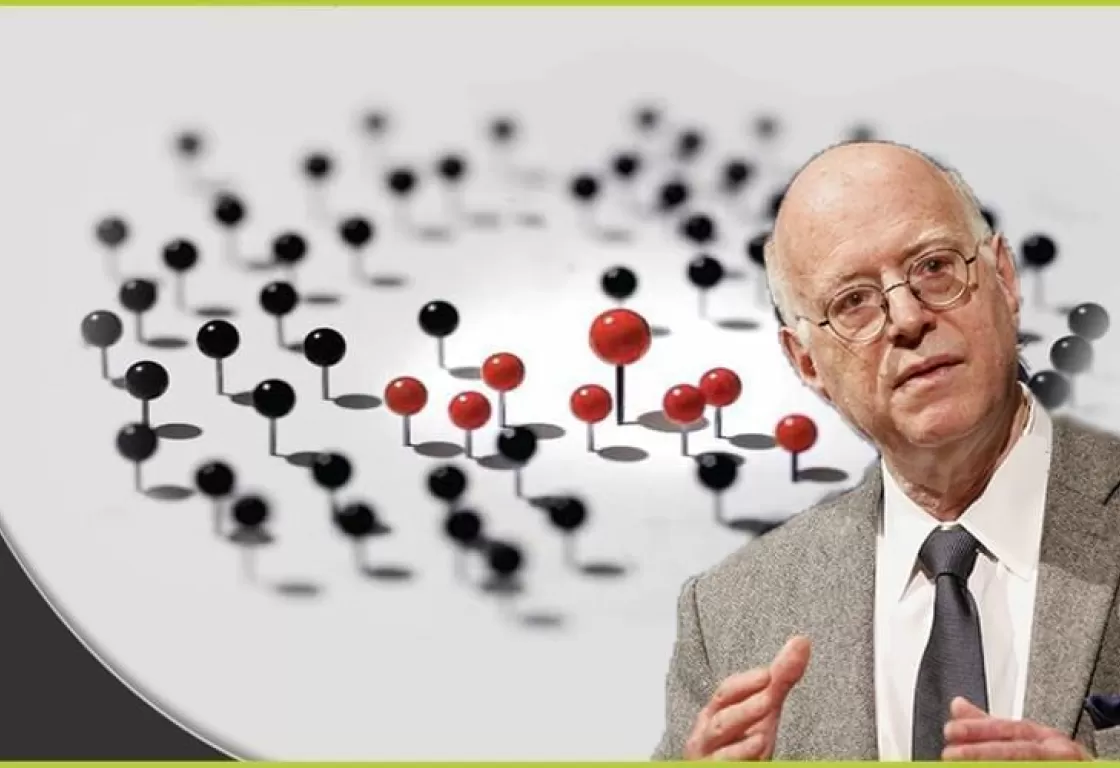
{وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصّلت، الآية 34).
يذكّر أستاذ علم الاجتماع الأمريكي، ومؤلّف كتاب "في مواجهة التعصب.. التعاون من أجل البقاء"، ريتشارد سينيت، الذي ترجمه حسن بحري، وصدر أخيراً عن دار الساقي، بأنّ التعاون موجود في جيناتنا، لكنّه يلزمه تطويرٌ وتعميقٌ. وهذا أمرٌ يكتسب أهميةً خاصةً عندما نتعامل مع بشرٍ لا يشبهوننا؛ حيث يكون التعاون جهداً مطلوباً، والتفكير في التعاون على أنّه مسألةٌ أخلاقيةٌ، يعيق فهمنا، لكن يجب النظر إلى التعاون، ودراسته كحرفةٍ تتطلب من البشر مهارة في الفهم، واستجابة للآخر، كي ننجح في العمل معاً. لكن يبقى التعاون حرفةً شائكةً مليئةً بالصعوبات، ويكتنفها الغموض، وتقود في أحيان كثيرة إلى عواقب هدّامة.
أمارتيا سن: مقدراتنا العاطفية والإدراكية لا تحظى سوى بإدراك عشوائي في المجتمع الحديث
لقد تحركت الأمم، على مدى التاريخ، في بناء حضاراتها، ومواجهة أزماتها، مستلهمةً فكرة قديمة للإنسان كصانع لنفسه، صانع الحياة، هكذا نلاحظ الرابط بين الكيفية التي يصوغ بها الإنسان جهده الشخصي، والكيفية التي يقيم بها علاقاته الاجتماعية، وبين البيئة المادية المحيطة. وربّما لأجل ذلك تصعد، بقوةٍ مؤثرةٍ، الروابط القبائلية والعشائرية؛ لأنّها استجابات مدعومة بذاكرة وتجارب طويلة ومتراكمة في التاريخ، والذاكرة كما أنّها مصحوبة بمشاعر قوية من القرابة والانتماء والروابط، فهي تضامن مع آخرين مشابهين لنا، وبحث عن عدائيةٍ ضدّ من هو مختلف، كما أنّها، وهذا الأكثر حضوراً وأهميةً في التشكيل الغرائزي للكائنات الحية عمليات دفــاع طبيعي؛ لأنّ معظم الحيوانات الاجتماعية، هي قبائل تصطاد معاً على شكل قطعان، وتعلِّم حدود أراضيها لتدافع عنها، لذلك فإنّ الحالة الجماعية (سواء كانت قرابية أو دينية أو طائفية أو اثنية) ضرورة للبقاء.
يمكن للتعاون أن يترافق مع التنافس، ويمكن ملاحظة ذلك في الألعاب، وفي الأسواق، والانتخابات، والمفاوضات الدبلوماسية، وليس شرطاً لأجل أن نتعاون، وأن نكون متضامنين في كلّ شيء، أو تربطنا مشاعر قوية من الانتماء والمودة، فالمهارة هـي أهم ما يحتاجه التعاون، والمهارة هي تقنية إحداث أمرٍ ما، أو إجادة صنعه، وكان ابن خلدون يرى أنّ المهارة ميزة الحرفي.
يقول أمارتيا سن: إنّ "مقدراتنا العاطفية والإدراكية، لا تحظى سوى بإدراك عشوائي في المجتمع الحديث، فالأشخاص قادرون على القيام بأكثر ممّا تسمح لهم المدارس وورشات العمل، والمنظمات المدنية، والأنظمة السياسية، القيام به. وأظنّ أنّه في مقدور العرب اليوم اكتشاف أنفسهم من جديد، وملاحظة الطاقات الكامنة لإعادة بناء عقدٍ اجتماعي ديمقراطي، يتسع لهم جميعاً بلا استثناء".
ربّما ينقصنا في عالم الصراعات والأزمات العربية القائمة اليوم، سواء كانت حروباً أهليةً طاحنةً، أو نزاعاتٍ وأزماتٍ داخلية، الحوار والإصغاء الحسن والعميق لبعضنا، والقدرة على المتابعة الحثيثة، وتأويل ما نقوله لبعضنا، والبحث عن معنى الإيماءات والصمت، والكلمات أيضاً. فالجدل والحوار، بسبب ذلك، لا ينتجان أفكاراً جديدةً، ولا يعززان التعاون؛ لأنّنا، كما يقول ثيودور زيلدن، "لا نكتشف المشترك مع الآخر"، أو كما يقول الناقد الأدبي الروسي ميخائيل باختين: "كيف يمكن للناس أن يصبحوا أكثر وعياً بوجهات نظرهم، نتيجة عملية التبادل بينهم، وأن يزيدوا من فهم أحدهم للآخر، على رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى اتفاقات مشتركة؟".
ويبدو واضحاً اليوم، في خضمّ ما نشهده من العنف المجتمعي، والشجارات، والسلوك الاجتماعي المتوتر، والاحتقان، أنّ من أهم أولوياتنا وضروراتنا القصوى، بناء ثقافة العفو والتسامح والمصالحة؛ فالمدن تقوم على القانون والتسامح، وفي غيابهما، تصبح الحياة مستحيلة، وربما يكون مهماً أيضاً أن يكون التسامح والتعاون مجالاً مشتركاً، بين مؤسسات البحث، ومنظّمات المجتمع المدني، والجامعات، والمدارس، وأن يشاركوا في التعلّم والتدرّب، كما التعليم والتدريب أيضاً، معلمون وأكاديميون ونشطاء من المجتمع المدني، ذلك أنّ الإنجاز والتقدم يقعان دائماً، أو في أغلب الأحيان، في التخوم المشتركة بين المؤسسات والتخصصات. وكما يكون التسامح والتعصب والتعاون عمليات تشغل العملية التعليمية، وبيئتها، وكمساعدة المعلم في نشر وتطبيق مفاهيم وآليات للمصالحة وحلّ النزاعات؛ فإنّها عملية تقع في سياق شبكة من المجتمع والمؤسسات التعليمية.
لا نحتاج، لأجل التدريب على التعاون والتسامح ومواجهة التعصب، إلى صراعاتٍ وأزماتٍ اجتماعيةٍ عنيفةٍ
لا نحتاج، لأجل التدريب على التعاون والتسامح ومواجهة التعصب، إلى صراعاتٍ وأزماتٍ اجتماعيةٍ عنيفةٍ؛ إذ تكفي استطلاعات الرأي، والدراسات المسحية، والملاحظات، لإدراك حجم العنف والتعصب، والسلوك غير الاجتماعي، في العمل والحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية والشخصية، إنّها مبادرة مليئة بالتحديات بالطّبع، لكن لا مناص من مواجهتها؛ بل تأخرنا كثيراً في التصدي لها؛ ففي الوقت الذي نجحت الدول الغربية، وكثير غيرها، في وقف الحروب والنزاعات لعقود متواصلة، بعد قرون من العداء والدماء، ما نزال، في مجتمعاتنا المتجانسة لغوياً وثقافياً، غير قادرين على التسامح والحوار والاستماع. المسألة ليست ترفاً، كما يظنّ البعض، لكنّها ضروريةٌ أساسيةٌ لأجل إتمام كلّ مشروعات الإصلاح والتنمية، حتى تلك التي يبدو أنّ لا علاقة لها بالموضوع؛ فالاقتصاد والموارد، والمصالح، تقوم اليوم على الثقة والتسامح. وهكذا، فإنّ التسامح رأسمال، هائلٍ وكبيرٍ، يطور السياحة والأسواق والعلاقات التجارية والاقتصادية، إضافةً إلى المكاسب الاجتماعية والعامة بالطبع. وبغير التسامح، فإنّ الأعمال والمشروعات والمؤسسات تتعرض لنزفٍ وخسائر كبيرةٍ جداً، عدا أنّه من الواضح أنّ الأزمة، في أبعادها الاجتماعية والأمنية، وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر، وتهدّد مكاسب وإنجازات قائمة، تحققت بالفعل، وأنفق عليها الكثير من الموارد والضرائب، كما تعطّلت آفاق ومسارات الإصلاح القادمة.
لكنّ التعاون والتسامح ليس فقط مجموعة من القيم والأخلاق؛ بل إنّ هذا الجانب في التعاون لا يشكّل سوى جزءاً ضئيلاً من مهارات وتقاليد العيش المشترك، وفي ذلك فإن العمل للمستقبل والخروج من الأزمات والصراعات في فضائه الاجتماعي العام، غير الرسمي، يعتمد على عمليات إصغاء، واسعةٍ وعميقةٍ، بين الأطراف، والفئات، والطبقات، وجميع المكونات الاجتماعية، فالتفكير في التعاون كمسألةٍ أخلاقيةٍ يعيق فهمنا.


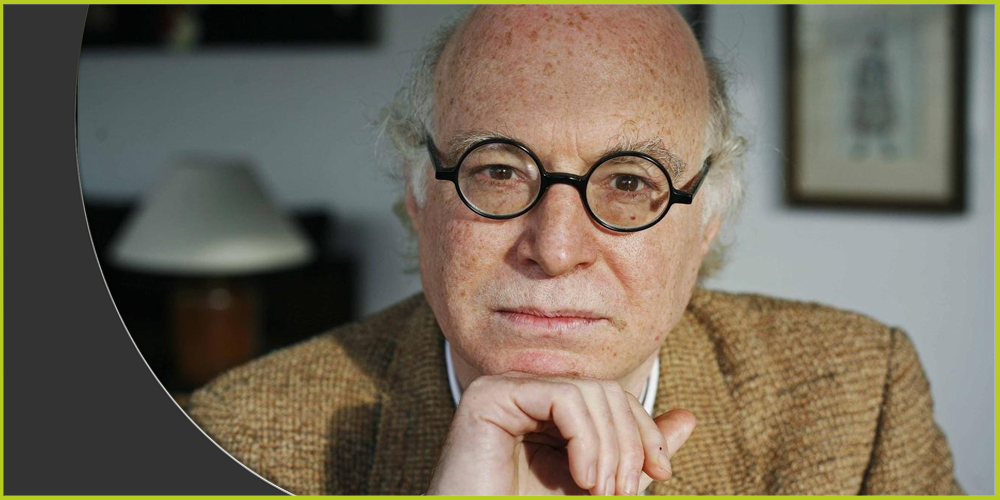

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/g1_1_0.jpg.webp?itok=G79shThP)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/taaaa_0_0_0_0.jpg.webp?itok=FzzzFHwG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_162_0.jpg.webp?itok=XKJf_Sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_63_0_8_0.jpg.webp?itok=BDMbKc_I)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_4_0_0_1_0.jpg.webp?itok=YqqMyIP6)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_1_0_0_1_0_0.jpg.webp?itok=NaGIRPy6)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/jly_5.jpg.webp?itok=6OoiDb6D)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/320245214338451859503_0_0_0.jpg.webp?itok=1w3HGcUv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0.jpg.webp?itok=mKmo_T5S)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%861_2_0.png.webp?itok=hdGbwfib)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/00_59.jpg.webp?itok=9pXj2Dv1)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_15.jpg.webp?itok=1nsmOsxK)







![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)


