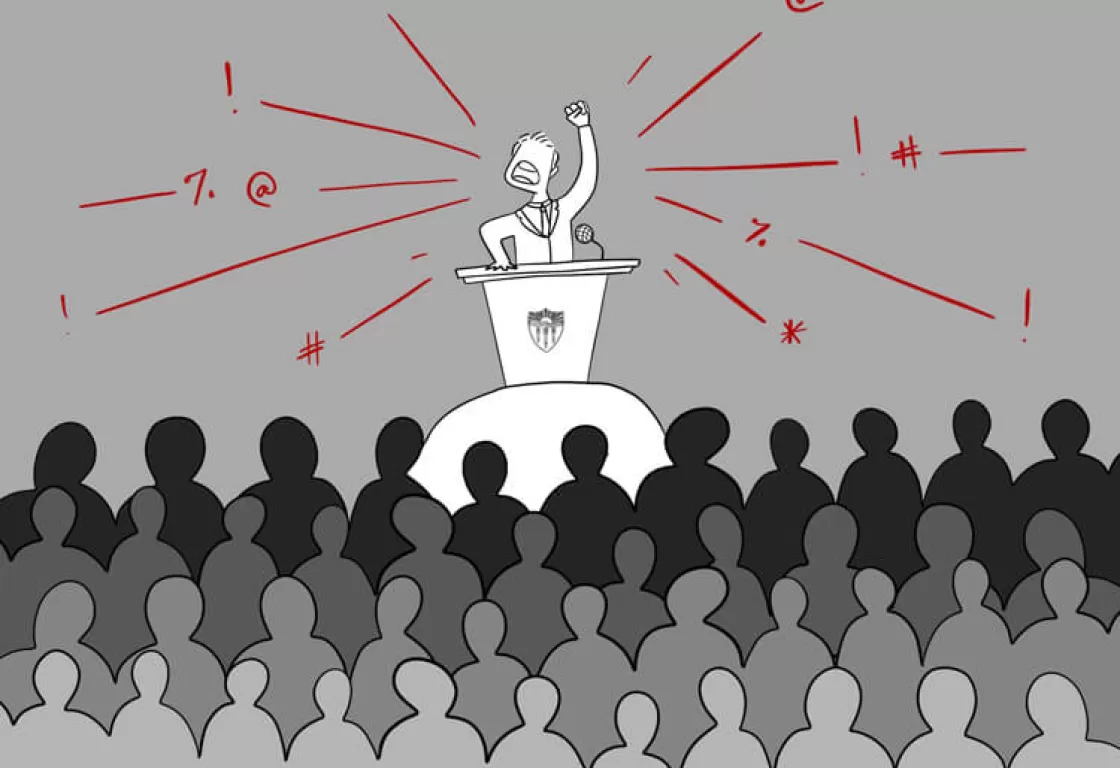
محمد خلفان الصوافي
لا يحدث كثيرًا أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي بموافقة جماعية من كل أعضاء المجلس دون استثناء. ومن تلك القرارات التي لم تشهد أي اختلاف أو تحفظ عليها، القرار رقم (2686) الذي صاغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الأمن خلال شهر يونيو 2023 ومعها المملكة المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن، وهو الذي يقرر أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب تسهم في اندلاع الصراعات وتصاعدها وتكرارها[1]، ويمنح هذا القرار شعوب العالم آمالًا (ولو محدودة) للتفاؤل بمواجهة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الإرهاب والتطرف. ورغم ذلك، فإن ما فعلته السلطات السويدية بالسماح لشخص بحرق المصحف في أول أيام عيد الأضحى المبارك يطرح تساؤلات عن نتائج الجهود الجماعية التي تقوم بها دول العالم في محاربة التطرف والإرهاب. لكن ردة الفعل الدولية التي أجبرت الحكومة السويدية على فتح التحقيق في الحادثة، أعادت إحياء تلك الآمال المبنية على القرار الاستثنائي الصادر عن مجلس الأمن، وأعطت إشارة بأن العالم حين يتحد ويتكلم بصوت واحد، فإنه بإمكانه وضع حد للكراهية والتطرف.
وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل باتت الظروف الدولية مؤهلة للجزم بأن العالم دخل مرحلة جديدة في جهود مواجهة التطرف والإرهاب من أجل دعم التسامح والتعايش الإنساني؟ وهل يمكن الحديث عن الانتقال إلى مرحلة العمل الميداني والاضطلاع بجهود استباقية لمنع النزاعات من تدمير العالم عبر أحد أهم مداخلها غير الظاهرة، وهو خطاب التطرف والكراهية على مستوى الخطاب السياسي والديني؟
هذان السؤالان مهمان لأن التجارب التاريخية في مواجهة الإرهاب والتطرف أثبتت الحاجة إلى الإجماع العالمي. حدث ذلك في مواجهة تنظيم “القاعدة” بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ثم في مواجهة تنظيم “داعش” في العام 2014، ما يعني أنه بدون هذا الاجماع العالمي لا يمكن الحديث عن القضاء على الإرهاب أو أي ظاهرة تمثل تحديًا للإنسانية. لكن هذا لا يعني في المقابل تجاهل الجهود الوطنية من كل دولة على حدة، وإلا سيكون الأمر وكأنه إلقاء بالمسؤولية على عاتق الآخرين.
خطاب الكراهية.. الخطير
منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في ديسمبر من عام 1991، والساحة العالمية مفتوحة على حلقة مغلقة من العنف والعنف المضاد لا يملك أحد القدرة على إيقافها. حتى صار لا يمر علينا يوم دون انفجار أزمة جديدة في العالم رغم الجهود المبذولة لإيقافها، وكان الكاتب الأمريكي صمويل هنتنجتون[2] قد تنبأ بذلك في كتابه “صدام الحضارات” الذي صدر عام 1996[3]. ومع أن المسؤولية الأولى عن كل أفعال الإرهاب والكراهية تقع على عاتق التنظيمات الإرهابية التي تدعي زورًا أنها تمثل الدين الإسلامي الحنيف، مثل تنظيم “الإخوان المسلمون” و”داعش” و”القاعدة”، إلا أن الغرب هو الآخر يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية. وذلك من خلال الخطاب السياسي العنصري و”تعبئة” المجتمعات على أيدي اليمين المتطرف والسياسيين الشعبويين الذين يتبنون مواقف مستفزة للمختلفين عنهم، سواءً في العقيدة أو القادمين من مجتمعات أخرى في العالم كما حدث في أحداث فرنسا الأخيرة التي عرفت بأحداث “الفتى نائل”.
حاليًا، فإن النقطة المتفق عليها بين الجميع في العالم أن الإرهاب ظاهرة عالمية، اكتوى الجميع بها. بل إن أغلب التنظيمات الإرهابية في العالم – إن لم تكن كلها، وخاصة تلك تتحرك وفق أيديولوجيات دينية – تصنَّف على أنها تنظيمات عابرة للحدود والقارات، ومع ذلك فإن المواجهات التي قامت بها الدول من أجل القضاء عليها مازالت محدودة وليس لها ثقل يوازي حجم الخطر المتنامي، بل إن الجهود السياسية والإعلامية ركزت فقط على إلقاء كل طرف اللوم على الآخر. بل إن حالة اليأس التي تملكت البعض من جراء هذا الفشل جعلتهم يعتبرون أي محاولة هي نوع من العبث، وليس العجز فقط في فرض إجراء للحد من هذا الخطر.
فالغرب يعتقد أن منطقة الشرق الأوسط تحديدًا هي منبع خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب، مع أن الغرب نفسه يدرك حجم معاناة أهل المنطقة من الإرهاب، مقابل أن الشرق يبني موقفه على مساحة حرية الحركة التي تمنحها تلك الدول لأصحاب الأفكار المتطرفة وفق منطق حرية التعبير. وهو المصطلح الفضفاض الذي يعمل على تهييج أصحاب المعتقدات الأخرى، وهو المحرك الأساسي لما يحدث من نتائج وأفعال مدمرة للتعايش الإنساني. الأمر الذي يعني أهمية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية بالمشاركة، خاصة مع الاعتراف بأن الإرهاب لا دين له.
صحيح أن العديد من دول العالم تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف في العالم بمختلف الوسائل والأدوات التي لا تقتصر على الوسائل الأمنية؛ فهناك الجهود الإعلامية من أجل توعية الشعوب بخطرهم، والمناهج التعليمية التي تهدف لتنشئة جيل المستقبل على ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر المختلف معه. وحتى لا تكون تلك الجهود عشوائية، تم استحداث تشريعات قانونية وقواعد لتنظيم استخدام “المنبر” الديني والمنبر الإعلامي. وتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني كافة بما يحقق انتشار ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع الواحد من أجل الوصول إلى تكامل الجهود الدولية.
ووصلت تلك الجهود إلى استضافة أكبر قطبين دينيين في العالم قبل التصويت على القرار الدولي، وهما الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وممثل عن بابا الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغير أمين العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي[4] ليتحدثوا في مجلس الأمن حول أهمية إقرار فهم مشترك في محاربة التطرف، وذلك في جلسة خاصة للمجلس انعقدت في 14 يونيو 2023.
وبتزامن هذه الخطوة مع صدور القرار الدولي عن مجلس الأمن، تتبلور فرصة كبيرة ومهمة لقيام تحالف أممي بقيادة الأمم المتحدة لمواجهة خطاب الكراهية، وهذا ليس جديدًا فبعد كل معاناة إنسانية كبيرة يتم الاتفاق تحت مظلة الأمم المتحدة للخروج بصيغة تفاهمية للسيطرة على الموقف، كما حدث خلال أزمة جائحة كورونا.
وإن تحديًا بحجم الإرهاب والتطرف لا يمكن معالجته دون تحالف دولي يتحمل فيه المجتمع الدولي مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فالقرار كأنه يضع المسؤولية على الأمم المتحدة، وعندما يتم ذلك في مجلس الأمن وبتصويت الأعضاء الدائمين كلهم، فإن القرار يعني شأنًا كبيرًا، إذ يعبر عن موقف دولي جماعي حقيقي.
مضمون القرار
يجب الإقرار بوجود قلق لدى البعض، خشية أن يمنح القرار الدولي رقم (2686) للحكومات غير الديمقراطية أو المتسلطة مساحة أمنية للتضييق على حرية الفكر والتعبير، وملاحقة الأفراد الأبرياء العاديين. ويستشهد أصحاب تلك الهواجس بقوانين أصدرتها حكومة رواندا لإنكار الإبادة الجماعية في 2017[5]. غير أن القرار الدولي لو تمعّنّا فيه لوجدنا أنه ركز على خطاب “الكراهية” الذي يحفز على العنف باعتباره سبب كل السلوكيات البغيضة في المجتمعات الإنسانية، كالتطرف والإرهاب والصراعات والتمييز بين البشر. فهذه (الكراهية) ليست شعورًا فقط، وإنما هي عملية تفكيرية وأداة سياسية نتيجتها تعطيل العلاقات الإنسانية بكل جوانبها، لتؤدي في النهاية إلى كوارث ومآسٍ إنسانية. وتتضخم نتائجها الكارثية عندما تتبناها فئة لها حضور، وربما نفوذ لا بأس به في المجتمع، فتتحول إلى ماكينة ترويج للكراهية، ويصير من السهل اللجوء إلى العنف وممارسة القتل، وبالتالي تدمير المجتمعات[6].
وحيث يسعى القرار إلى تثبيت أركان استقرار المجتمعات الإنسانية في العالم، كانت تجربة حرق المصحف في السويد اختبارًا عمليًا وعاجلًا له. وقد أثبت نجاحه بوقوف أغلب الحكومات في العالم ضد تصرف الحكومة السويدية، التي تراجعت نتيجة لتلك المواقف.
ويحصر القرار جميع الأسباب المؤدية إلى التطرف والإرهاب، ما سيجعله مقبولًا لدى باقي المنظمات الدولية والإقليمية؛ لأنه يساعد الحكومات على ردع المتطرفين، وبالتالي الدفاع عن قيم العدالة الإنسانية[7].
ومن شأن تأمين الإجماع الدولي أن يفتح الباب أمام تطوير التحرك العالمي وربما إدخال مضمون القرار إلى القانون الدولي. وهو ما سيمثل بدوره نقطة تحول كبرى في تاريخ محاربة الكراهية. كما أن إشراك المؤسسات المجتمعية يجعل من القرار سلاحًا ناعمًا، ولكنه نافذ في الوقت نفسه ضد من يحاول العمل في الخفاء، خاصة وأن القرار يركز بالدرجة الأولى على الأسباب المؤدية إلى التطرف والإرهاب. وهي الخطابات الداعية إلى التمييز والكراهية والأدوات الداعمة لانتشار هذه الخطابات المدمرة للمجتمعات، ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي. فالمعنى الأشمل للقرار أنه يغلق الباب أمام ادعاءات المتطرفين الذين يزعمون الدفاع عن المعتقدات، فقد بات المجتمع الدولي يتكلم بصوت واحد ضد الخطابات الكراهية.
ومن بين القوى المجتمعية، لرجال الدين والإعلام أهمية خاصة ودور محوري، فكلاهما لديه القدرة على تشكيل اتجاهات المجتمع بواسطة الخطابات والرسائل التي يتلقاها على مدار الساعة. ووفقًا للقرار فإن الدور المطلوب من رجال الدين والإعلاميين هو نشر ثقافة التلاقي وتقليل الاختلافات والإكثار من الحديث عن ثقافة التعايش الإنساني، وتقبل الآخر، وتعزيز ثقافة التسامح.
في مستوى آخر، طالب القرار الدولي بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلبًا على السلام والأمن. وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو من العام المقبل 2024. فضلًا عن إبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار. إن تضمين القرار هذه الإجراءات العملية يؤكد أن التحرك العالمي بقيادة الإمارات بدأ يتخذ خطوات فعلية وتنفيذية، ولم يقف عند حد الربط الفكري أو إعلان بيان عام وفقط. وجدير بالذكر هنا أن صدور القرار جاء نتيجة لعمل متواصل ودؤوب قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المراحل السابقة. وإذ جاء القرار بعد محاولات متكررة سابقة لم يكتب لها النجاح، فإن هذا القرار يُتوقع له أن يحقق الكثير من المكاسب في اتجاه استقرار السلم والأمن الدوليين. وسيكون درسًا دوليًا في كيفية إغلاق المساحات ضد المتطرفين، وتجريدهم من الأدوات التي تمكنهم من الانتشار والتوسع في المجتمعات.
وهناك أمران ينبغي استحضارهما في الذهن ونحن نتحدث عن هذا القرار؛ الأمر الأول أن التجارب التاريخية أثبتت أن الفشل في مواجهة التحديات الكبرى، وخاصة الإرهاب والتطرف، يرجع بالأساس إلى عدم توحيد الجهود الدولية لمواجهتها. لكن هذا لا يعني وضع “كل البيض في سلة الأمم المتحدة” وتجاهل أهمية دور القوى المجتمعية مثل رجال الدين الذين يمتلكون سلطة روحية لا تقل في تأثيرها عن السلطة السياسية بل أحيانًا قد تتفوق عليها خاصة في المجتمعات الشرقية. وكذلك دور وسائل الإعلام، وتحديدًا وسائل التواصل الاجتماعي التي بدا كل حساب فيها يمثل كيانًا إعلاميًا مستقلًا، لهذا فإن القرار شمل هذين المكونين ومراعاة الشمولية في مضمونه وبنوده. وأما الأمر الثاني فصحيح أن المكاسب المباشرة من القرار لم تكن عاجلة، لكن في المقابل الكوارث المترتبة على خطاب الكراهية تؤكد حتمية منعه في أسرع وقت ممكن وبشتى السبل. والعمل الجماعي في الوقت ذاته من أجل صياغة إطار قانوني دولي يتصدى لحالة الانفلات التي دمرت الإنسانية.
المسؤولية الأخلاقية
من أبرز أسباب الإخفاقات الدولية في مواجهة الأزمات والصراعات هو ذلك التراجع أو الإخفاق أمام التحديات التي تأسست من أجلها المنظمات الدولية، سواء الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية.
وقد يكون السبب في ذلك الفشل احتدام التنافس بين الدول على النفوذ في العالم وخاصة الدول الكبرى؛ أي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك الدول المؤثرة في كل إقليم جغرافي. ولكن عندما يكون الخطر عالميًا باعتراف الجميع، فمن الطبيعي أن تسود حالة من الدهشة والانتقاد لموقف الصمت والتردد الذي يتملك الغرب، وخاصة أن الجميع متضرر وليس دولة أو دولًا معينة أو منطقة محددة في العالم دون غيرها.
وبالعودة إلى نهاية القرن العشرين، كان هناك اعتقاد غربي تحديدًا أن نهاية القرن العشرين يعني نهاية كل ما دار فيه من صراعات مباشرة أو تلك الحروب التي تدار بالإنابة. وأن التركيز خلال القرن الجديد سيكون مختلفًا وأنه سيحمل وعودًا تفاؤلية للإنسانية تتعلق بمستقبل أفضل في منظومة جديدة من القيم، تقوم على احترام التنوع الثقافي والانطلاق من مبدأ ليست هناك ثقافة أسمى من ثقافة[8].
إلا أن ما حدث مختلف تمامًا، حيث قامت حرب ثقافية عالمية بدأت مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبرغم أن العالم وقتها تكاتف ووقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، فإن واشنطن أساءت استغلال ذلك الدعم الدولي في إدارة علاقاتها مع المختلفين معها سياسيًا؛ مثل نظام صدام حسين في العراق وما تبعه من تداعيات أدت إلى تفكيك كيان الدولة العراقية، مما أدى إلى شكوك وتردد دولي في دعم مشاريع أمريكية لنشر القيم السياسية والمجتمعية المصوغة وفق المنطق الأمريكي.
واللافت أن أوروبا التي عانت كثيرًا من الإرهاب ثم من السياسات الأمريكية، كانت مواقفها مبهمة في محاربة أسباب التطرف. بدليل استضافة عناصر بعض التنظيمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين، على عكس العديد من دول الشرق الأوسط التي كانت تُتهم بأنها المصدّرة للأفكار المتطرفة، فهي التي عملت بشكل صريح وعملي وفعال في مواجهة خطابات الكراهية. ليس فقط بالوسائل الأمنية بل أيضًا بتشريعات وقوانين رادعة وبتبني مناهج فكرية وسياسات إعلامية مدروسة.
وبالتالي، فإن المغزى الأساسي من استصدار قرار دولي من مجلس الأمن يتمثل في بُعدين مهمين؛ البُعد الأول تعزيز الجهود والمساعي الوطنية للدول التي تحارب التطرف والإرهاب، والتي أخذت بعض جهودها سياقات دولية في التقريب بين الديانات، ويتمثل بعضها الآخر في استضافة منتديات ثقافية تركز على تأكيد أن الحوار بين الديانات والحضارات هو السبيل الأمثل لمعالجة الاختلافات، كما تفعل دولة الإمارات من خلال البيت الإبراهيمي، فهذا من شأنه تكامل الجهود الدولية.
وأما البُعد الثاني فهو تعميق ونشر الوعي لدى مؤسسات المجتمع المدني بمخاطر الخلافات التي يعتقد البعض أنها هامشية مع أنها تدمر المجتمعات المسالمة، حيث يركز بعض المتطرفين على الاختلافات بين المعتقدات وتعمُّد الابتعاد عن توضيح المشتركات والأفكار التي تقرب بين أفراد المجتمع الواحد. الأمر الذي يؤجج الصراعات على المرجعيات والهوية.
نقطة أخيرة، لن يستطيع العالم تفكيك الإرهاب والتطرف إلا بتجاوز ثقافة الكراهية. وفي ظل عالمية الظاهرة وتشابكها فإن المواجهات الفردية أو الجزئية لا يمكن لها إنهاء تداعيات هذا الخطاب وبالتالي على الجميع التشارك في هذه المهمة الصعبة.
وقد تحولت المبادرة الإماراتية إلى قرار دولي؛ لأنها هي الباب الوحيد للخروج من دوامات أخطر مسببات الإرهاب والتطرف العنيف التي دمرت دولًا ومجتمعات، وقتلت العديد من البشر في العالم، وهو توظيف الخطاب الديني والسياسي ضد الحياة بشكل عام. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن خطاب الكراهية ليس مقصورًا على مجتمع دون آخر. ويكفي هنا أن الحوادث والوقائع المرتبطة بالكراهية والتطرف توالت بشكل لافت خلال الأسابيع بل الأيام الماضية؛ فبعد حادثة السويد (حرق المصحف) ثم فرنسا (حادثة مقتل الشاب نائل) أقدم شاب متطرف في روسيا على محاولة جديدة لحرق القرآن الكريم، لولا أن السلطات هناك أوقفته وأجهضت محاولته.
وفي هذا التسلسل والمعدل المتزايد لتلك الأحداث دليل كافٍ على حاجة الجميع للعمل بشكل مشترك؛ لأن أي معالجات محلية لقضايا عالمية، مهما تكن فعالة وناجحة، تظل غير مجدية، حيث إن منابع الظاهرة ومصادر الخطر ليست محلية فقط بل عالمية أيضًا، وكذلك يجب أن تكون المواجهة هكذا عالمية.
عن "تريندز للبحوث والاستخبارات"


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85_12_0.jpg.webp?itok=bn7GiVg5)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A_68.jpg.webp?itok=qzf_9Qhn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_12_1.jpg.webp?itok=1YuOVU6G)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_17_2_0_0.jpg.webp?itok=tq04KrD0)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9_1_8.jpg.webp?itok=tUGkKyum)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%201_2_1_0.png.webp?itok=fR4LK_tm)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/thumbs_b_c_2458b79a7d586854385078ffb776fcf8_0_0_5_0.jpg.webp?itok=J3b49HfH)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/202451171138475R9.jpg.webp?itok=htrAjPBR)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2_0_0.jpg.webp?itok=orTDmkyy)




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/IMG_7998_0.jpeg.webp?itok=q8INZVDS)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7_7_0_0.jpg.webp?itok=JtXmHRWb)



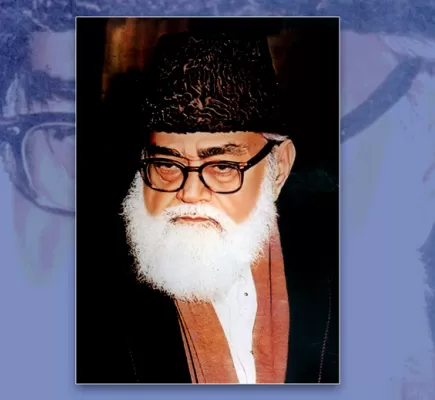



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)

